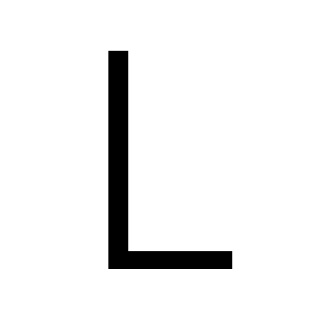زعتر قرب الحدود
جيني غوسطافسونكتابة
جيني غوسطافسونتصوير
انجلا سعادةبحث
نسرين كاجتحرير
فوزي يمينترجمة
حصاد الزعتر في حقول الجنوب؛ الزعتر عشبة متأصّلة في التقاليد الغذائيّة اللبنانية والفلسطينية

الزعتر، عنصر أساسيّ في المطبخ اللبناني والفلسطين
تمسك إحداهنّ، سوزان عطية، بحزمة من سيقان الزعتر الرفيعة المتلاصقة، وتقطعها من قاعدتها بسكّين، ثمّ ترتّبها بيدها. وتنحني من جديد لتقطف المزيد؛ سرعان ما أصبح لديها باقة كثيفة الأوراق.
“يشتهر الجنوب بالزعتر. صحيحٌ أنه موجودٌ في أماكن أخرى من لبنان، لكنّنا هنا مرتبطون به ارتباطًا وثيقًا”، تقول إحدى النساء الأخريات، ماجدة بطرس، وهي تحمل أيضًا باقة خضراء بين يديها، مربوطة برباط مطّاطي. تخطو خطوتين، ثمّ تتّجه نحو أحد الصناديق وترمي الزعتر فيه.
بالكاد كان قد انبلج ضوء الصباح، حين وصلت مجموعة من النساء إلى حقل صغير على أطراف بلدة قانا التي تقع في ريف جنوب لبنان الجبليّ، وهنّ يرتدين ملابس مريحة، وينتعلن أحذية رياضيّة، ويحملن مجموعة من صناديق الخضراوات السود الفارغة.
الأرض تحت أقدامهنّ صخريّة ومغطّاة بالنباتات الخضراء، منها الحشائش وأنواع مختلفة من الأعشاب الضارّة، لكن بين الحجارة والأوراق ينمو أيضًا نوع من العشب المحبوب الذي هو سبب مجيئهنّ إلى هنا اليوم: الزعتر.

تقول ماجدة: “للزعتر ثلاثة مواسم: في الشتاء نقطف الزعتر الأخضر، كما أنّ هناك موسمًا يبدأ في يونيو وآخر في سبتمبر”.
تُعدّ قانا، بمناخها الجافّ وتضاريسها الجبلية، مكانًا مثاليًا لزراعة الزعتر. إذ ينمو هذا العشب هنا في البرّية، حيث يجمعه الناس لاستهلاكهم الخاصّ، وحيث يزرعونه في مشاتل لبيعه في السوق. بعضه يُؤكَل طازجًا، لكن معظمه يُجفّف ويُخلَط مع بذور السمسم والسمّاق لصنع خلطات أعشاب تُعرف أيضًا باسم الزعتر.
إنّ معظم أنواع الزعتر المقطوفة في لبنان، بما في ذلك زُوبَع التعاونيّة، هي إمّا أوريجانوم سرياكوم (يُسمّى أحيانًا “أوريجانو لبنانيّ” أو “أوريجانو سوريّ”) أو أوريجانوم إهرنبرغي، وكلاهما نوعان من الأوريجانو موطنهما لبنان وشرق البحر الأبيض المتوسط. يتميّز هذا الزعتر بأوراق ناعمة، تشبه الرّيش، صغيرة، مستديرة ومثاليّة للتجفيف. ويمكن أن يكون الزعتر من أنواع مختلفة من الزعتر البرّي، أكثر صلابة وذات أوراق طويلة ورفيعة. وعندما لا يتمّ تجفيفه، يُضاف هذا الزعتر غالبًا إلى السلَطات، وعادةً مع أوراق الجرجير والبصل.
تضيف ماجدة، مشيرةً إلى النباتات الصغيرة الكثيفة ذات اللون الأخضر الباهت التي تنمو حول قدميها: “الزعتر الذي نزرعه هو من نوع الزُوبَع”.
فعلى الرغم من أنّ الزعتر يُذكر بصيغة المفرد، غير أنه في الواقع أكثر من ذلك بكثير. إنه اسم عام لعدد من الأعشاب المختلفة التي تنتمي إلى الفصيلة الشفوية (Lamiaceae) النباتية الأكبر، والتي تشمل نباتات كالخزامى، والمريميّة، والأوريجانو، والريحان، وإكليل الجبل، والزعتر البرّي.
تعاونيّة قانا تجمع الزعتر في الصباح الباكر، حين يكون هواء الحقول لا يزال باردًا



في لبنان (وأماكن أخرى في المنطقة)، تتداخل الأسماء وتختلف. فإلى جانب الزوبَع، هناك أيضًا زعتر داق أو دقي – وهما كلمتان مشتقّتان من الجذر نفسه لكلمة “الدُقّة”، وهو اسم لعدد من خلطات الأعشاب والمكسّرات والتوابل المختلفة التي تُؤكل في المنطقة، وأكثرها شيوعًا في مصر. كما أنّ العديد من اللبنانيّين يقولون ببساطة: “زعتر برّي”، عند الإشارة إلى النباتات التي تُجمَع.
المؤكّد هو أنّ هذه الأعشاب المختلفة، تُشكّل جزءًا من التاريخ الاجتماعيّ والطهويّ للمنطقة. فعلى سبيل المثال، تُعدّ فصيلة الأوريجانوم فصيلة أعشاب متوسّطية: 35 من أصل 43 نوعًا منها توجد فقط في شرق البحر الأبيض المتوسط (وأربعة فقط في غربه). تنمو هذه الأعشاب، بشكل رئيسيّ، في المناطق الجبليّة، ليس بالضرورة على المرتفعات العالية، بل يُفضّل أن تنمو على المنحدرات الصخريّة. في الواقع، يُترجَم اسم الأوريجانوم، المُشتقّ من الكلمتين اليونانيّتين أوروس (جبل أو تلّ) وغانوس (فرح، احتفال)، إلى “بهجة الجبال”.
يُقال إنّ الطريقة الأكثر شيوعًا لتناول الزعتر هي تجفيفه، إذ يُخلَط بزيت الزيتون ويُدهَن على عجينة المنقوشة، ثمّ يُخبَز لبضع دقائق في فرن كبير. تتنوّع خلطات الزعتر هذه، لكن جميعها تقريبًا تحتوي على بذور السمسم والسمّاق، وهي توابل لاذعة تُصنع من مسحوق بذور السمّاق. كما توجد خلطات كالزعتر الحلبيّ، الذي يحتوي على قائمة أطول بكثير من المكوّنات، كدبس الرمّان والفستق الحلبيّ والشومَر والكزبرة.
وفي المخابز في جميع أنحاء لبنان، من الشائع أن يجلب الناس زعترهم الخاصّ – المحصود والمجفّف في المنزل – لاستخدامه بدلًا من زعتر المخبز.
وعندما نشرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) معيارًا للزعتر عام 2020، أدرجت أربعة أجناس نباتيّة قد تظهر في خلطات الزعتر الجافّة: الأوريجانو، الزعتر المتوسّطي، الغدّة الزعتريّة وزعتر الجبل. وكلّ جنس من هذه الأجناس الأربعة، بمفرده، هو أصلٌ لأنواع مختلفة من الأعشاب.
والشاعر محمود درويش الذي وثّق جوانب عديدة من الثقافة الفلسطينيّة في كتاباته، يذكر الزعتر في قصيدته “أحمد الزعتر” التي كتبها في أعقاب مجزرة تلّ الزعتر عام 1976 في بيروت، حيث يقول: “إلى يدين من حجر وزعتر/ هذا النشيد/ إلى أحمد المنسيّ بين فراشتين”. في حوارٍ دار عام 1986 مع سلمان رشدي، قال إدوارد سعيد، وهو يتحدّث مع صديقه الكاتب عن وجبة الفطور: “إنّ وجود الزعتر في البيت الفلسطينيّ علامةٌ على عراقة البيت الفلسطيني”. (ومؤخّرًا، قال الطبّاخ فادي قطان: “الزعتر هو ما تجدونه على مائدة الفطور في كلّ بيت فلسطيني، أينما كان في العالم”).
يستمرّ المشهد الطبيعي لجنوب لبنان، بتلاله الملساء وأراضيه الصخرية، على نحو مماثل في فلسطين، حيث يحمل الزعتر أهمّية مماثلة، إن لم تكن أكبر. وكما هو الحال مع اللبنانيّين، دأب الفلسطينيّون على البحث عن الزعتر وأكله عبر التاريخ. وقد أصبحت هذه الأعشاب والتاريخ المرتبط بها، رمزًا لانتماء الشعب الفلسطينيّ إلى وطنه، وقد ربطته مباشرة بالأرض التي أُجبر على النزوح عنها. يقول المثل: “نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون”.

لقد سبق ذكر الزعتر في كتاب عن الطبخ صدر عام 1936 باللغتين الإنجليزية والألمانية، مع ترجمات عبرية، باسم المنظمة النسائية الصهيونية الدولية، بعنوان “كيف تطبخ في فلسطين”. تدعو المقدّمة ربّات البيوت إلى “تحرير” مطابخهنّ من “العادات الأوروبية التي لا تنطبق على فلسطين”. حيث يُذكر الزعتر، أو كما يُشير الكتاب، “الزعتر الجميل”، كمثال على النباتات التي يُمكن البدء بزراعتها. كذلك، يجسّد النعناع مثالًا آخر، إذ رأى المؤلّفان أنه لا ينبغي “استخدامه من قِبل العرب فقط”، بل أيضًا “زراعته في المستعمرات اليهودية”.
وهناك أمثلة أخرى على القوانين الإسرائيلية التي تستهدف التراث الطهوي والزراعي الفلسطيني، كحظر العكّوب (نبات برّي مهمّ آخر) عام 2005، وتجريم امتلاك ورعي الماعز الأسودرعي الماعز الأسود (أكثر حيوانات الماشية شيوعًا في فلسطين قبل عام 1948) في خمسينيّات القرن الماضي.
كما أنّ اسماعيل هنيّة، الزعيم السابق لحركة حماس الذي اغتيل في طهران، أثار أيضًا الأهمّية السياسيّة للزعتر عندما قال في خطاب شهير له عام 2006: “سنأكل الزعتر والعشب والملح، لكنّنا لن نستسلم أو نتخلّى عن مبادئنا”.
قبل عقود، وتحديدًا عام 1977، فرضت الحكومة الإسرائيليّة – عندما كان أرييل شارون وزيرًا للزراعة – حظرًا على حصاد الزعتر البرّي. وكان يتمّ تغريم جامعي الزعتر، إن وُجد بحوزتهم نباتات، أو تُصادر أعشابهم. وكان السبب المعلَن بيئيًا هو أنّ الزعتر مُعرّض لخطر الانقراض. لكن الحظر اعتُبر – بل وُجد – خطوة لاستهداف الثقافة، والتراث، والحياة الاقتصاديّة الفلسطينيّة. كما تزامن هذا مع زيادة حادّة في زيادة حادّة في زراعة الزعتر في إسرائيل: مثال على الممارسة الاستعماريّة المتمثّلة في محو ما يُعتبر “برّيًا”، وتحويل هذا التراث إلى مخطّطات تُفيد المستعمِر.
“دمّروا كلّ شيء في منطقتنا: الكنائس، المساجد، الأراضي الزراعية، الأشجار، المنازل. كلّ شيء”، تقول فاتن سرحان.
تجلس في الأريكة في غرفة معيشة مشمسة في بلدة جزين الجبلية، تطلّ على المنحدرات الصخريّة. بجانبها والدتها، عفيفة سرحان، وشقيقها محمّد سرحان. جاءت العائلة إلى جزين عندما أصبحت الحياة في قريتهم كفركلا، الواقعة على الحدود الجنوبية ومن بين أكثر المناطق تضرّرًا خلال الحرب، محفوفة بالمخاطر.
على الجانب الآخر من الحدود، في جنوب لبنان، تعرّضت الممارسات الغذائية والزراعية لأشكال مختلفة من الهجوم منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. حيث استُهدفت الأراضي بشكل مباشر، واقتُلعت الأشجار ودُمّرت، ومُنع الناس من الاعتناء بأراضيهم وحصاد محاصيلهم. وقد نشر البنك الدولي مؤخّرًا تقديرًا للأضرار بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي، و7.2 مليار دولار أمريكي من الخسائر الاقتصادية. وكانت محافظتا النبطية والجنوب، الواقعتان في أقصى جنوب لبنان، هما الأكثر تضرّرًا.



أمّ ابراهيم وأنطوان حداد، زوج ماجدة بطرس، يحتفظان ببعض الزعتر لعائلتيهما ولا يبيعانه
تزرع العائلة العديد من المحاصيل في أرضها بكفركلا، بما في ذلك الزيتون وجميع أنواع الخضراوات. ويدير علي، ابن عفيفة الآخر، حسابًا شهيرًا على إنستغرام بعنوان “أرضي“، حيث يشارك مقاطع فيديو لوالدته وهي تطبخ وتشتغل في الأرض. كما تمتلك العائلة مطعمًا يقدّمون فيه الطعام الذي يزرعونه في أرضهم.
توضّح عفيفة: “لا نستخدم الأسمدة الكيماوية؛ نؤمن بالطرق الطبيعية في الزراعة. وعندما يزرع المرء بنوايا حسنة، ينمو كلّ شيء بشكل جيّد”.
كما أنّهم يزرعون الزعتر في قطعة أرض مجاورة لمنزلهم.
يقول محمد: “في مرحلة ما، بدأنا نشهد على موت الناس، واحدًا تلو الآخر”.
“في آخر مرة كنت فيها في كفركلا لحضور جنازة، توقّفتُ لريّ الأشجار القريبة من منزلنا. سرعان ما أدركت أنني نسيت بعضها، لكنّني قلت لنفسي: لا تقلق، يمكنك فعل ذلك غدًا”. ثم، عندما عدت في اليوم التالي، كانت كل شجرة قد اختفت. قصفوا القرية في ذلك الصباح”.
يجلب محمد فنجانًا صغيرًا من القهوة على صينية من المطبخ، وهو يقول: “حتى تلك اللحظة، كنا نستخدم كلّ ما لدينا من مياه لإنقاذ أشجارنا وأرضنا، وقد نجحنا في الحفاظ على كلّ شيء وإبقائه حيًّا”.
“نخلط الزعتر بزيت الزيتون وقليل من الملح. وسواء كان طازجًا أو مجفّفًا، فالأفضل تناوله بهذه الطريقة”.
تقوم التعاونية بتصنيع البسكويت والمقرمشات بالزعتر، والتي تُباع في بيروت وغيرها، بالإضافة إلى المنقوشة المصنوعة من دقيق القمح الخاصّ بها. كما تُحضّر خلطاتها الجافّة بنفسها.
هنا تقول سوزان: “عادةً ما نُحضّر خلطة خاصّة بنا، مختلفة عن تلك التي نبيعها. تحتوي على كمّية أقلّ من السمسم، ممّا يُبرز نكهة الزعتر بشكل أكبر. ونضيف المزيد من السمّاق إليه، لأنّ حموضته تتلاشى قليلًا عند خبز الزعتر على المنقوشة في الفرن”.
تكمل عفيفة شرحها: ” “زعترُنا” يُروى بمياه الأمطار، ما يعني أنّ نكهته أقوى. إذ عند ريّه، يفقد بعضًا من نكهته. لا يحتاج الزعتر إلى الكثير من الماء، وفي المقابل يحتاج كثيرًا إلى ضوء الشمس”.
ويضيف محمّد: “لدينا الزعتر العادي، والزعتر البرّي، الرفيع الطويل، الذي نستخدمه في بعض الأطباق لإضافة النكهة. وهو لذيذ جدًا مع الشنكليش”.
تصرّح عفيفة أنّها، قبل كلّ شيء، تحبّ تناول الزعتر ممزوجًا بزيت الزيتون الذي تدهنه على خبزها. كما تفضّله ماجدة أيضًا بالطريقة نفسها.

غادة وماجدة بطرس، مؤسِّستا مشروع تعاونيّة زراعة الزعتر في قانا
تشرح ماجدة: “ذهب بعضنا للإقامة مع أقاربه، بينما استأجر آخرون أماكن إقامة أو لجأوا إلى المدارس والكنائس”.
“أُجبرنا على الرحيل عام ٢٠٠٦ أيضًا، لكن الأمر كان مختلفًا هذه المرّة. كنا بصدد الإخلاء حين بدأت القنابل تتساقط من حولنا. حتى أنّ انفجارًا وقع بجوار سيّارتنا مباشرةً”.
عندما بدأت الغارات الجوية الإسرائيلية تُدمّر البلدات والقرى في جميع أنحاء الجنوب، كانت قانا واحدة من بين العديد من القرى التي تعرّضت للهجوم. فاضطرّت الأخوات وغيرهنّ من أعضاء التعاونية إلى الفرار، كما هو الحال مع سائر سكان الجنوب. وفي ذروة النزوح في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، غادر نحو 900 ألف شخص، أي ما يُعادل خُمس سكان لبنان، إلى جميع أنحاء البلاد.

عفيفة سرحان من بلدة كفركلا، حيث تزرع العديد من المحاصيل والخضراوات المختلفة
توضح سوزان: “فاتنا الموسم بسبب الحرب. وعندما سنحت لنا الفرصة أخيرًا للزراعة، لم نجد أيّ نوع من البذور للقيام بذلك”.
في كفركلا، كان الوضع أسوأ بكثير. دُمّر جزء كبير من القرية بشدّة، وتحوّلت منازل عديدة إلى أنقاض. وتُظهر صور الأقمار الصناعية وصور أخرى، دمارًا في أماكن كانت تدبّ فيها الحياة – البشرية والنباتية – في السابق.
يقول محمد: “هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل كفركلا، بل على العكس تمامًا. كانت القرية من أوائل القرى التي احتلّتها إسرائيل في لبنان عام 1978″.
وعندما عادت النساء إلى قانا، وجدنَ العديد من نباتاتهنّ ميّتة. لم تُستهدَف بشكل مباشر، إنّما جفّت بسبب نقص المياه.
تعترف سوزان: “تُركت النباتات لشهرين بلا رعاية. وفي حين نجا بعضها، اقتلعناها وزرعناها في قطعة أرض أخرى لإنقاذها”.
عادةً تزرع التعاونيّة قمحها الخاصّ لصنع البرغل والدقيق المستخدم في خبزها. لكن هذا العام، لم تتمكّن من زراعة أيّ شيء على الإطلاق.
يعتبر محمّد أنّ تلك الفترة أضعفت ارتباط الناس بالأرض: “دُمِّر كلّ شيء خلال الاحتلال. غادر الجيل الأكبر سنًا مع أطفاله؛ وسافر الكثيرون إلى الخارج للعيش والدراسة. وقد خلق ذلك فجوةً امتدّت لأكثر من 20 عامًا، انقطع خلالها تواصل الجيل الجديد”.
بعد أربع سنوات، في عام 1982، عادت القوات الإسرائيلية وبدأت احتلال جنوب لبنان الذي استمرّ حتى عام 2000. خلال تلك الفترة، انتُهكت استقلاليّة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية باستمرار. فلم يكن من الممكن مغادرة المنطقة والعودة إليها إلّا عبر نقاط تفتيش أقامتها إسرائيل فوق الأراضي اللبنانية وكانت هي تسيطر عليها.

كانت السياسات القمعيّة التي فُرضت خلال الاحتلال، محاولةً لتدمير الزراعة تدريجيًا في الجنوب. ضُرب نوع من الحصار على الخضراوات وسواها من المنتجات، في حين سيطرت البضائع المُستوردة من إسرائيل على السوق.
تُركت الحمضيّات لتتعفّن على الأشجار، ولم يكن المزارعون يعلمون ما إذا كانت ثمارهم ستصل إلى المُشترين في بيروت والشمال.
ثمّ يردف عفيف: “كنت الوحيد في العائلة الذي بقي في القرية آنذاك. أرسلتُ الأطفال إلى بيروت، ومكثتُ في المنزل لأُظهر أنّ أحدًا لا يزال يسكن هنا”.
وتشرح ماجدة أنّ عائلتها في قانا مرّت بظروف مماثلة: “خلال حرب عام 2006، وافقت والدتي على المغادرة، لكن والدي رفض. حتى في عام 1996، عندما جاءت قوات اليونيفيل لمرافقة الذين تمّ إجلاؤهم، تجنّبهم وعاد إلى المنزل. خلال هذه الحرب، لم يغادر أيٌّ منهما”.
تُركّز عفيفة في كتاباتها، بشكل كبير، على التبغ، وهو محصول مهمّ في جنوب لبنان. بالنسبة لمزارعي التبغ أو غيره من المحاصيل، لا تقتصر الحياة على المواسم الزراعية فحسب، بل تتبع أيضًا “مواسم الحروب” المتكرّرة. وهكذا، تكتب منيرة عن الحرب كيف أنّها “تصعّب الحياة لتصبح جزءًا من أدواتها وزمكانيّتها، حيث “تجد الكائنات الحيّة سبُلًا للتعايش معها، وبالتالي مقاومتها”.
مؤخّرًا وقبل الحرب الحالية، طال الفتك جنوب لبنان عام 2006. وتصف عفيفة كيف فرّت من كفركلا خلال حرب تموز التي استمرّت شهرًا في صيف ذلك العام.
في هذه الأثناء، واصل الناس التحايل على هذه الشروط المفروضة ومقاومتها. منيرة خيّاط، عالمة الأنثروبولوجيا، تستكشف هذا الأمر في عملها. حيث يتمحور بحثها عن جنوب لبنان حول مفهوم الحرب، وكيف تُشكّل هذه العمليّات جزءًا من الحياة اليوميّة للناس. تقول إنّ الحرب – عندما “تُرى من الجنوب” بعكس ما هو شائع سواءً في الأوساط الأكاديمية أو الإعلامية، “عندما تُرى من الشمال” – ليست حدثًا استثنائيًا أو “مختلفًا”، بل هي بنية كغيرها من البنى الأخرى التي تُشكّل حياة الناس وتفاعلاتهم. إنها شكل من أشكال العنف، كما تقول منيرة، “منسجم مع تشكيلات السلطة” و”مُولِّد لعوالم اجتماعية”.


أمّ ابراهيم تجمع الزعتر لبيعه في تعاونية قانا

يقول عفيف: “دائمًا ما يطلب الناس منتجات منزليّة الصنع كمربّى المونة والزعتر. استقبلنا ضيوفًا من الكويت، ونيجيريا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية ودول أخرى”.
يُؤتى بالزعتر الذي يقدّمونه ويبيعونه، بشكل رئيسيّ، من النباتات البرّية، وليس من تلك التي تنمو بالقرب من منزلهم. فبعد زراعة الأشجار في الجوار، تعرّض الزعتر لظلال كثيفة ممّا أثّر سلبًا على نموّه.
فتقول: “في البداية، صمدنا. لكن بعد ١٧ يومًا، طُلب منا المغادرة. وكنت خائفة. كانت ابنتي في السادسة من عمرها فقط آنذاك. توجّهنا بالسيارة إلى البقاع، بينما كانوا يقصفون السيارات خلفنا”.
لم تكن عفيفة وأطفالها يملكون مطعمًا في ذلك الوقت؛ فقد افتُتح لأول مرة خلال جائحة الكورونا. ومنذ ذلك الحين، حافظوا على استمراريّة عملهم، حتى في أوقات الشدّة.
فتشرح غادة: “بعض الناس يُحبّون النكهة القويّة للزعتر المُزهر، بينما يُفضّل آخرون الطعم الأخفّ للزعتر الورقيّ، ومن الشائع استخدام كليهما في الخلطات”.
حتى لو كان الزعتر ينمو طبيعيًا في الجنوب، فإنّ زراعته تتطلّب الكثير من الجهد.
“لذلك، بدأنا بتوظيف عمّال لحصاد الزعتر في البرّية، وهو، في أيّ حال، أطيب أنواع الزعتر”، يردف عفيف.
تختلف النباتات المزروعة عن تلك التي تنمو في البرّية، كما هو الحال مع الزعتر الذي يُقطف خلال فترة إزهاره.

اضطرّت عفيفة وعائلتها إلى مغادرة منزلهم وأرضهم في كفركلا، وأقاموا في بلدة جزين الجبلية منذ بدء الهجمات الإسرائيلية
أبعد بقليل، وأثناء ملء آخر صندوق بالزعتر، تعمل امرأة تُدعى أمّ ابراهيم مع ابنتها. هما من حلب في سوريا، لكنّهما عاشتا وعملتا في جنوب لبنان لسنوات عديدة.
تقول أمّ إبراهيم: “عملنا مع الجمعيّة التعاونية لثلاث سنوات. بخلاف ذلك، غالبًا ما نعمل في مجال التبغ. يوجد الكثير من التبغ هنا”.
هنا تصرّح ماجدة: “إنه عمل شاقّ. يتطلّب الكثير من التحضير، من حرث التربة وتوفير الريّ المناسب، إلى زرع النباتات في مساحة كافية تسمح لها بالنموّ جيّدًا”.
تقول هذا وهي تُشير إلى الأرض المحيطة بها، حيث وُضعت شرائط من النايلون الأسود للحفاظ على رطوبة التربة ومنع نموّ الأعشاب الضارّة.


كذلك أدّت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من الرعاة والصيّادين، وفي الأول من مايو/أيار، بعد خمسة أشهر من وقف إطلاق النار. قُتل أيضًا أسامة فرحات، وهو ناشط بيئي معروف باهتمامه برعاية الحيوانات البرّية.
أمام كلّ هذا، تشعر نساء قانا بالقلق إزاء المستقبل.
تقول ماجدة: “عندما عدنا من الحرب، غمرتني مشاعرٌ كثيرة. حتى أنني قلتُ للآخرين: “دعونا نغلق التعاونية”. فعلى مدى عامين، لم نحقّق أيّ تقدم، وتجمّدت مدّخراتنا. ظللتُ أسأل نفسي: “ما جدوى القيام بهذا؟”.
ثم بدأوا يفكّرون في تجربة منتَج جديد: الزعتر المقطّر، الذي يمكن تعبئته وإضافته إلى الشاي، أو العصير، للمساعدة في تقوية جهاز المناعة وتخفيف السعال والبرد.
تشرح ماجدة: “لدينا بالفعل بعض النباتات التي سنمارس عليها هذه التجربة، بحيث أنّنا احتفظنا بالبعض من أجزائها وجذوعها المتبقّية”.
“لكن حصاد الزعتر أسهل. أمّا بالنسبة للتبغ، فيجب البدء بقطفه، ورقة ورقة، في وقت مبكّر جدًا، في الرابعة أو الخامسة صباحًا.”
كغيرها من العائلات، فرّت أمّ ابراهيم وعائلتها عندما قُصف الجنوب. ومن بين 900 ألف نازح جرّاء الحرب، لم يقتصر الأمر على اللبنانيّين فحسب، بل امتدّ إلى عائلات سورية تعمل في قطاعات كالبناء والزراعة في جميع أنحاء الجنوب، بالإضافة إلى عمّال من السودان، وبنغلاديش، وإثيوبيا، ودول غرب أفريقيا، كانوا يعيشون ويعملون في لبنان.
ولا يزال عدد ضحايا الحرب في ازدياد. ففي ديسمبر/كانون الأول، وبعد أسبوع واحد من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، صرّح وزير الصحّة اللبناني، فراس أبيض، بمقتل 4047 شخصًا في هجمات إسرائيلية. وفي أبريل/نيسان، أفادت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمقتل 71 مدنيًا على الأقلّ بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، والعدد يزداد باستمرار.

يُؤكل الزعتر عادةً على خبز المنقوشة، أو يُخبَز في أفران كبيرة، أو على صاج معدنيّ
تخرج عفيفة وأطفالها إلى الشرفة الخلفيّة للمنزل الذي يستأجرونه في جزين. بجوارها قطعة أرض صغيرة يزرعون فيها خضراوات متنوّعة. ونظرًا لارتفاع جزين الشديد عن البحر، عليهم القيام بتجربة أساليب ومحاصيل جديدة. في هذه الأثناء، وحتى عودتهم إلى كفركلا، يواصل علي مشاركة مقاطع فيديو لوالدته وهي تزرع، وتحصد، وتطبخ، وتُعِدّ المحفوظات.
لطالما استُخدمت النباتات البرّية، بما فيها أنواع الزعتر، في الطبّ الشعبيّ عبر التاريخ. فالأوريجانو والزعتر غنيّان بالثيمول، وهو زيت عطريّ، وبالكارفاكرول، وهو فينول (مركّب عضوي عطري)، وهما يتميّزان بخصائص مطهّرة ومضادّة للأكسدة. في لبنان وفلسطين والمناطق المحيطة، يُعرف الزعتر بفائدة واحدة خاصّة: تنشيط الدماغ. وعادةً في اليوم السابق للامتحان، ينصح الآباء أبناءهم بأكل الزعتر أو شربه.