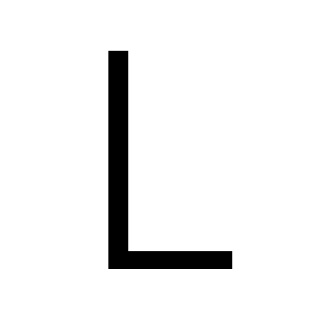القمح في عكار
جيني غوسطافسونكتابة
جيني غوسطافسونتصوير
انجلا سعادة, يارا وردبحث
نسرين كاجتحرير
فوزي يمينترجمة
تحضير الفريكة مع علياء هزيم وعائلتها في بلدة حرار الشمالية

علياء حازم تحمل حفنة من باقات القمح الثقيلة على وشك تحميصها على النار المفتوحة لتصبح فريكة
تثبّت عينيها على حجر تحت ظلّ شجرة، مسطّح وكبير بما فيه الكفاية للجلوس براحة عليه. فوق الأرض بضعة أكوام من القمح ذات سيقان طويلة، جاهزة تترقّب وصولها. فالقمح هو ما أتى بعلياء إلى حرار، قرية والدتها، في هذه اللحظة بالذات؛ إنه الوقت المناسب من العام لحصاد القمح الأخضر وتحميصه لإنتاج الفريكةة، وهو مادّة أساسية محبوبة للغاية في حجرة المؤن اللبنانية.
تستلقي نوفا على الأرض بينما تلتقط علياء الجالسة على الحجر، خصلة تلو الأخرى من كومة القمح، وتجمعها في حزمات متينة.
في جبال عكار في شمال لبنان، يرتسم طريق متعرّج عبر بلدة حرار الصغيرة، وبجوار مخبز صغير ينحرف طريق آخر مرصوف بالحصى إلى اليمين لينتهي أخيرًا بين حقول صغيرة مكسوّة بالأعشاب. علياء هزيم، تعبر هذا الطريق وهي ترتدي وشاحًا مربوطًا حول رأسها للوقاية من الشمس، ونوفا، كلبتها، تتبع خطواتها. إنه صباح من أواخر الربيع، وقد وصلت علياء للتوّ من بيروت.
“بحبّ كون صلة وصل بين الريف والمدينة، بجي لهون وباخد معي شو مطلوب بالمدينة،” تفصح علياء.

يتّسم القمح الذي ينمو على سفوح حرار بجذور تاريخية عميقة، حيث يُعتقد أنّ الهلال الخصيب هو مركز منشأ عائلة النجميّات Triticeae من الأعشاب البرّية التي ينتمي إليها القمح والذرة والشعير، ولا يزال من الممكن العثور على أقدم أسلاف القمح الحديث – وحيد الحبّة، ثنائيّ الحبّة، والحنطة – التي تنمو هنا في البرّية.
تُعدّ المنطقة أيضًا موطنًا للمزارعين الأوائل في التاريخ إذ يعتقد العلماء أنّ القمح قد تمّت زراعته لأول مرة في جبال كاراكاداغ في جنوب شرق تركيا، منذ أكثر من 10000 عام، وبهذه الحبوب المزروعة بدأت الزراعة كما نعرفها.
ومع ذلك، استهلك البشر القمح لمدّة طويلة قبل تلك الفترة. وقد تمّ العثور على أقدم دليل معروف لصناعة الخبز في الصحراء السوداء في الأردن، في موقع أثريّ عمره 14000 عام، كما أنّ المصريّين القدماء كانوا أيضًا من أوائل صانعي الخبز عندما لم يستخدموا الحبوب لتصنيع الجعة.
وتقول: “هيدي المرحلة من شغل الفريكة أكتر شي بتاخد وقت، بس مفيدة كتير”.
في كلّ مرة تلتقط فيها خصلة، تقوم بفحصها عن كثب للتأكّد من عدم وجود رؤوس ناضجة في الحزمات، إذ ينبغي أن يُصنَع الفريكة فقط من القمح الأخضر للحصول على قوام مطّاطي مميّز ونكهة جوزيّة.
يتقدّم رجل يعتمر قبّعة زرقاء نحو علياء وذراعاه ممتلئتان بالقمح، يلقي به فوق الكومة على الأرض، ثمّ يعود ليجمع المزيد منه. يعمل الرجل، خالد البعريني، مع المزارعين في حرار عندما يحتاجون إلى المساعدة أثناء موسم الحصاد.
“شوف هالنعمة، هيدا هوّي حلا ألله”، يقول خالد وهو يسير بين النباتات الطويلة ذات اللون الرملي.
من المؤكد أنّ القمح اكتسب أهمّية لدى الإنسان أكثر من أيّ نوع آخر من الحبوب. فهو غنيّ بالبروتينات والكربوهيدرات، ويتحمّل الظروف القاسية، ويمكن تخزينه أو تداوله بسهولة. ويتمّ إنتاجه اليوم على نطاق أوسع من أيّ نوع آخر من الحبوب، ويوفّر حوالي 20 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية في العالم.
في المدن والقرى اللبنانية، لطالما كان القمح ضروريًا للحياة.
إذ يُعدّ الخبز والبرغل من العناصر الأساسية المهمّة، ويستمرّان في تشكيل جزء من معظم الوجبات. في أوائل ومنتصف القرن العشرين، حين كان غالبيّة اللبنانيّين يعيشون في الريف، كان يتمّ إنتاج معظم كمّيات القمح محليًا. واليوم، يتمّ استيراد كلّ شيء تقريبًا.
ثمّ انتشرت فيما بعد أنواع مختلفة من القمح مع حركة البشر على طول طريق الحرير وعلى الطرق البحرية. حمل المزارعون الأوائل ما تسمّيه مجلّة Nature مجموعة “أدوات العصر الحجري الحديث” التي تحتوي على المحاصيل والحيوانات والأدوات الزراعية. وأثناء رحلتهم إلى أوروبا وإفريقيا وشبه القارة الهندية، قام المزارعون بزراعة القمح في هذه المواقع الجديدة. وقد تكيّف القمح – كما له بالعادة أن يفعل – مع ظروف مختلفة، وطوّر تنوّعًا وراثيًا كبيرًا.
وقال عالم الآثار بروس د. سميث في مقال نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن القمح القديم: “يحتاج البشر فقط إلى الشروع بالزراعة والحصاد، وبمجرّد أن يقوموا بذلك، تستجيب النباتات”.

علياء تبحث عن القمح ذي الحبوب الخضراء لربطها في باقات
“ليش منزرع هيدا القمح؟ بدنا نخلّي الناس يشوفوا إنوّ فينا نزرع قمح، هيدا مش حلم، ممكن يصير حقيقة،” يقول سيرج للناس.
الكثيرون يتّفقون مع سيرج، لكن صاحب مخبز كبير يقول إنّ الأمر ليس بهذه البساطة، إذ إنه يحتاج إلى شراء القمح بكمّيات كبيرة وبالخصائص نفسها في كلّ مرة، ولا يمكن للقمح المحلّي أو الموروث تلبية هذه المطالب.
تعود هذه المسألة إلى منتصف القرن الماضي، عندما حدث تحوّل كبير في إنتاج القمح العالمي، حيث أتاحت سلسلة من الابتكارات الزراعية المعروفة باسم الثورة الخضراء زراعة كمّيات أكبر بكثير من ذي قبل، وقد جاءت استجابة للنموّ السكاني العالمي، وغيّرت طبيعة الزراعة في جميع أنحاء العالم.
ويصرّح سيرج حرفوش، عضو مزرعة ومكتبة البذور في جمعيّة “بذورنا جذورنا”: “نستورد 550 ألف طن من القمح كلّ عام، أو 90 بالمئة ممّا نستهلكه”.
يجلس سيرج وسط دائرة كبيرة من الناس في مزارع القمح التابعة للجمعيّة في سهل البقاع. إنه يوم مشمس من شهر حزيران، والمجموعة تستضيف مهرجانًا للحبوب القديمة، حيث يمكن للناس مقابلة الخبّازين والمزارعين. تُوضع الأرغفة والخبز المسطّح المصنوع من القمح الموروث على الطاولة، وتنبسط الحقول ذات اللون الرمليّ من بعيد.
تزرع جمعيّة “بذورنا جذورنا” 44 نوعًا من القمح في تلك الأراضي، وجميعها مزروعة من أصناف قديمة. وقد كان وادي البقاع تاريخيًا بمثابة صوامع التخزين لقمح الإمبراطورية الرومانية. أمّا اليوم، فإنّ عددًا قليلًا من الناس يزرعون القمح هنا.


خالد البعريني، وهو أيضًا من بلدة حرار، ويتمتّع بخبرة طويلة في زراعة وحصاد المحاصيل، ينضمّ إلى علياء وعائلتها في الحقول عندما يحين وقت الحصاد

ربّما شهدت الهند التغيير الأكبر على الإطلاق، فلقد تحوّلت من كونها مستوردًا رئيسيًا إلى احتلالها المركز الثاني بين أكبر مصدّري القمح في العالم. وكان لهذا التحوّل ثمن باهظ حيث تمّ تدمير بعض أفضل الأراضي الزراعية في شبه القارة الهندية، وتلوّثت الأنهار والبحيرات، وانخفض التنوّع البيولوجي.
إنّ جميع أنواع القمح التي زرعتها جمعيّة “بذورنا جذورنا” في سهل البقاع هي ذات أصناف تراثية، وكذلك النباتات التي تنمو في أرض علياء ووالدتها في عكار.
في هذا الوقت، كبرتْ كومة القمح عند قدمي علياء، وقد انضمّت إليها والدتها حسنا علي وأحد أفراد أسرتها مال الحسن. تجلس حسنا على الأرض، وتمدّ ساقيها وسط أكوام القمح.
تزرع العائلة نوعين مختلفين من القمح، وكلاهما من أصناف محلّية. والحقول الصغيرة التي يعملون فيها اليوم مليئة بالبيّاضي الصالح لصنع الفريكة، والبرغل، والقمحيّة التي هي نوع من العصيدة المصنوعة من القمح المقشّر.
“الناس بالضيعة بيقولوا إنو إذا حدا ما بياكل البياضي، متل كأنّو ما إكل شي بحياتو”، تصرّح حسنا وهي تلتقط القمح الناضج جدًا لتتخلّص سريعاً منه.
تمّ إدخال أصناف جديدة من القمح يمكنها الاستجابة بشكل أفضل للريّ وتأمين غلّات أوفر. غير أنها تطلّبت استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، حيث تمّ تعديل المقاومة الطبيعية للآفات والأمراض الموجودة في القمح القديم.
فانخفض مثلاً مستوى ارتفاع القمح القديم، حيث كان يمكن أن يصل ارتفاع الأصناف القديمة إلى 170 سنتيمترًا، ممّا يمكّنها من التغلّب على الأعشاب الضارّة. ولكن في المقابل لا يمكن رشّها بالأسمدة، لأنّ ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى الإطاحة بها. لذلك، استقدم العلماء جينات متقزّمة، وخاصة من صنف ياباني يُسمّى نورين 10، لتكوين مجموعة جديدة من القمح القصير. وسرعان ما انتشر هذا النوع في جميع أنحاء العالم، حيث أنّ أكثر من 70 بالمئة من قمحنا اليوم يحتوي على نورين 10 في جينوماته.
ارتفع إنتاج القمح العالمي بشكل كبير في تلك السنوات، من 700 مليون طن سنوياً في الخمسينيات إلى 1.9 مليار طن سنوياً في نهاية القرن. غير أنّ هذا كان يعني أيضاً اختفاء عدد لا يُحصى من أصناف القمح المحلّية من أراضي المزارعين ومن أطباق الأكل لدى الناس.
في ذاك العهد، كان كلّ أبناء القرية يعملون معًا أثناء موسم الحصاد. في المساء، كانوا يجتمعون ويغنّون، ويتبادل الجميع المنتجات، مثل البرغل واللبن الزبادي الضروريّ لصنع الكشك، وهو منتج من القمح المخمّر ومنتجات الألبان.
“النسوان والبنات كانوا يعملوا الإشيا الصعبة”، تقول حسنا، “هنّي اللّي يحصدوا والرجال يزرعوا”.
حتى أنّ الكلمة التي تشير إلى المرأة التي تحصد، “الحصّادة”، اكتسبت اسمها آلة الحصاد الحديثة.
توضح حسنا: “بالقديم كانت حياة المزارعين حلوة، بس كتير صعبة”.
مثل كثيرين آخرين في الجبال، تمتلك العائلة قطعة أرض في الجرد، وهي منطقة شبه قاحلة على ارتفاع عالٍ، على بعد مسافة من القرية، حيث يزرعون هناك القمح السلموني.
“هيدي حبّة قمح قديمة وما بتعطي كتير”، تعترف علياء، غير أنّها “النوع الوحيد اللّي بيقدر يعيش بالصقعة”.
و”ميشان هيك سمّوها بالسلموني” تشرح علياء، “لأنّو معناها “سالمة من التلج”، يعني ما بتنتزع بالتلج”.
مال، التي تجلس بجوار علياء، تتناول خيطًا لربطه حول الحزمة في يدها، وتقول: “بالقديم كنّا نجدّل القمح، ما كنّا بوقتا نستعمل الخيطان”.



تقول: “بس الناس ما عجبتن طعمة القمح. وكمان لأنّو حجمو كان قصير، ما طلع منّو كتير تبن للشغّيلة.”
كان من الشائع في ذلك الوقت أن يقوم المزارعون بإعطاء التبن الباقي من الحصاد كدفعة للأشخاص الذين يعملون معهم، والذين سيستخدمونه بعد ذلك علفًا لحيواناتهم.
تُعدّ حسنا اليوم واحدة من القلائل الذين يزرعون القمح في حرار، وربما هي الشخص الوحيد الذي يصنع الفريكة الخاصّ بها. وفي السنوات التي أعقبت الثورة الخضراء، شهد لبنان – مثل العديد من البلدان الأخرى – تحوّلاً من القمح الموروث عن الأسلاف إلى القمح التجاري. وهنا تتذكّر حسنا كيف وفدت الحكومة إلى بلدتها وزرعت فيها أصنافًا جديدة.
واليوم، وبعد مرور أكثر من قرن، تبدو أوضاع الأكل والغذاء قاتمة مرة أخرى. ويواجه الآن حوالي مليوني شخص في لبنان انعدام الأمن الغذائي نتيجة للأزمة المالية بشكل أساسي، ولكنه يتفاقم أيضًا بسبب عدم المساواة والاستغلال والقضايا البيئية. فمنذ بدء الأزمة في عام 2019، ارتفع سعر القمح عدة مرات. وأصبحت هشاشة الوضع واضحة مع الصراع في أوكرانيا، حيث يحصل لبنان على 80.4 في المئة من القمح المستورد (أضف إلى ذلك 15.5 في المئة من روسيا).
اليوم، حوالي ثلثي الأراضي الزراعية في لبنان مملوكة من قبل 10% من أفضل ملّاكي الأراضي، والعديد منهم مرتبطون بشخصيات سياسية.
ويصف مقال نشره مركز كارنيغي للشرق الأوسط هذا الأمر بأنه أشبه ب”قبضة احتكار القلّة” للسوق. أضف إلى ذلك السياسات الزراعية للبلاد، والتي كانت لفترة طويلة موجّهة نحو المحاصيل النقدية والتصدير. يعود كلّ ذلك إلى بداية لبنان كدولة حديثة، ومجاعة 1915-1918 التي أعقبت تحوّلًا من الغذاء المحلّي إلى تصدير المحاصيل مثل الحرير.

مال الحسن، إحدى أقارب علياء، صنعت الفريكة لمرّات لا تحصى خلال حياتها

وهذا يعني أنّ القمح المحلّي أفضل دائماً من الحبوب المستوردة القادمة من البعيد.
لقد انطوى القمح دائمًا على معنى رمزيّ.
فهو يمثّل الخصوبة والوفرة والهبة، وغالباً ما يرتبط بالمرأة لقدرتها على وهب الحياة ورعاية المجتمع على حدّ سواء. وقد كانت إلهة الزراعة في الأساطير الرومانية واليونانية، المعروفة باسم سيريس في الأولى وديميتر في الثانية، تُصوَّر عادةً مع حزمة من القمح في يدها أو تاج من القمح على رأسها.
وقد قامت العديد من الدول بإدراج القمح في شعاراتها، بما في ذلك الصين وبوليفيا وجنوب أفريقيا والعديد من الدول السوفياتية السابقة. فلقد احتلّ القمح مكانة مركزية في الجماليّات السوفياتية، فظهر على العديد من فسيفساءاتها وجداريّاتها. كما أنّ العلم الأوكراني، بخطّه العلوي الأزرق وأسفله الأصفر الذهبي، يمثّل السماء فوق حقول من القمح لا نهاية لها. كما استخدمت أفغانستان القمح في العديد من أعلامها إلى أن استولت طالبان على السلطة فيها.
وقد وصف فرانك أوكوتر، أستاذ العلوم الإنسانية البيئية، النظام الزراعي العالمي بأنه أشبه ب”علاقة سيّئة” في إحدى حلقات برنامج “السلسلة الغذائية” الذي تبثّه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وأضاف: “ولكن على عكس العلاقة السيئة، لا يمكنك الخروج منها والبحث عن شيء آخر”.
تقصد علياء المخبز الصغير عند مفترق الطرق في عكار لتشتري المناقيش للإفطار. كانت قد مرّت عليه في وقت سابق من ذلك الصباح ومعها زعتر والدتها وزيت الزيتون، ليقوم الخبّاز بخلطهما فوق العجين قبل خبزه.
عندما تعود إلى الحقل، يأخذ الجميع استراحة ويتبادلون الأحاديث. تتذكّر حسنا لقاءها بوالد علياء والزواج منه، قائلة بأنّ ذلك قد حدث في مثل هذا الوقت من العام لأنّ القمح كان له اللون نفسه.
ثمّ تردف: “بضيعتنا بيقولوا إنّو إذا تجوّز حدا من عنّا بنت من غير ضيعة، متل لعم ياكل قمح جايي من ورا البحر”.
تقول حسنا: “ما رضي ببيّي يكون تحت سلطة البكوات، ميشان هيك اشترى أرض لإلو تا ياخد وحدو المحصول”.
وكان من الشائع أيضاً الطلب من الأسر الزراعية دفع الضرائب على إنتاج القمح والدقيق، أو الفريكةة. ومع كلّ المشقّة التي يتطلّبها صنع الفريكة، قام المزارعون بإنتاجه فقط لمنحه للحكام المحلّيين.
“ميشان هيك الناس سمّو حسنا “إمّ عبود”، ع إسم زوجة من زوجات البك الختيار، “لأنّو كانت مشهورة بصنع الفريكة”، تقول مال مبتسمة.
كانت الشمس فوق رؤوسهم قد بلغت وسط السماء، حين انتهوا من المرحلة الأولى من قطاف الفريكة. كانت رؤوس السنابل الباقية على الأرض، شاحبة، بلون القشدة، وناضجة جدًا بحيث لا يمكن وضعها في أيّ من حزمات القمح. تمسك علياء بحفنة من الحزمات وتبدأ بحملها إلى السيارة.
تقول: “بتذكّر وقتا كنت طفلة، كان في ربطات قمح ما بقدر إحملن. بيبيّنوا زغار، بس وقتا بيجي الواحد تا يشقلن بيلاقين تقال”.
تُرجِع اللغة الإنجليزية أصل العديد من كلماتها إلى القمح أو الخبز، مثل كلمة “lord” التي تنبع من الكلمات الإنجليزية القديمة التي تعني رغيف وحراسة، وتعني حرفيًا “حارس الخبز” أو “رفيق” المشتقّة من الكلمة اللاتينية التي تعني الخبز.
وكثيرًا ما يُقتبس عن سقراط قوله شيئًا على غرار: “لا يمكن اعتبار أيّ إنسان رجل دولة، إذا كان جاهلًا تمامًا بمشكلات القمح”.
في العديد من البلدان، بما في ذلك لبنان، كان القمح أيضًا وسيلة لدفع الضرائب. فقد طُلب من المزارعين اللبنانيّين إعطاء حصّة من محصولهم للعائلات الثريّة وذات النفوذ المعروفة باسم البكوات (أو البك بصيغة المفرد)، والتي تمّ منحها السلطة المحلّية أثناء تفكّك الإمبراطورية العثمانية. وقد فرضوا ضريبة تُسمّى “عاشر”، تشتقّ تسميتها من الكلمة العربية التي تعني عشرة، والتي أجبرت العائلات على دفع حصّة من أراضيهم أو حيواناتهم إذا لم يكن بحوزتهم المال. بهذه الطريقة، تمكّنت العديد من العائلات الإقطاعية من السيطرة على أراضي المزارعين.

حسناء علي، والدة علياء، مشهورة في حرار بمعرفتها في صنع الفريكة
تقول: “كلّ شي بعرفو عن الأرض تعلّمتو من إمّي، من كلّ شي كانت تعملو بهالسنين. طبّقت كلّ شي أخدتو منها”.
ولعمليّة التحميص هدف مزدوج: تجفيف الحبوب، ومنحها نكهة سميكة ومدخّنة.
تقول القصة إنّ الفريكة بدأ كخطأ محظوظ. في وقت ما من الماضي، تعرّضت قرية في منطقة جبل عامل في جنوب لبنان لهجوم من العدوّ، واشتعلت النيران في جميع محاصيلها. وبعد انتهاء الحصار، تمكّن القرويّون من إنقاذ القمح المحترق عن طريق فرك التبن الأسود، فوجدوا حبّات محمّصة لذيذة بداخله.
وسرعان ما تمّ توضيب القمح في صندوق السيارة. يعودون أدراجهم بالسيارة عبر الطريق الصغير، ويصلون إلى منزل حسنا في غضون دقائق. وعلى الفور، بدأت حسنا بالتحضير للمرحلة الأخيرة: تحميص القمح على نار مفتوحة.
يقوم خالد بجمع العيدان والأوراق الجافّة من الحديقة، ويجمعها في كومتين صغيرتين. تقوم مال بإعداد كومة ثالثة وتضع فوقها مرجلًا كبيرًا من الماء. حسنا تشعل النار في الأكوام، بينما تذهب علياء لإحضار الحزمات من السيارة.

في حديقة حسنا، تقوم المجموعة بتحميص القمح عن طريق غرز الحزمات مباشرة في النار. يتمّ تقليب كلّ حزمة بعناية، بحيث تصل النار إلى جميع الحبّات. وأخيرًا، يتمّ وضعها في المرجل حتى تُسلَق بسرعة.
يعود تاريخ الفريكة إلى زمن بعيد. ورد ذكر الحبوب المحمّصة عدة مرات في العهد القديم، بين الأطعمة التي حملها داود عندما التقى جالوت، وكهديّة حبّ قدّمها بوعز لراعوث. كما يحتوي أحد كتب الطبخ في بغداد في القرن الثالث عشر على وصفة “الفريكةةيّة”، وهي طبق من الحبوب واللحم المطبوخ في الزيت والماء ولحاء القرفة.
واليوم، يُؤكل الفريكة في جميع البلدان المجاورة.
يستخدمه المصريون في حشو الحمام أو الدجاج، ويأكلونه مع الأسماك على طول الساحل. في الأردن وفلسطين، يحظى الفريكة بشعبية كبيرة في الحساء مثل شوربة الفريكة المصنوعة من البصل واللحم. وغالبًا ما يقدّمه اللبنانيون على أطباق مزيّنة بالدجاج واللوز أو المكسّرات الأخرى. ويرتبط بشكل رئيسي بالجنوب، حيث تشتهر قرية شمعة بصنع الفريكة الجيّد.
تقول حسنا: “بحبّ أعمل الفريكة لأنّو هيدا من تراثنا. ربيت معو. وما في أحلى من إنّو الإنسان ياكل من أرضو”.
جلستْ فوق جدار منخفض من الإسمنت، بجوار شجرة زيتون قديمة في الحديقة. تأخذ قشًا من إحدى الحزمات وتقشّره، ممّا يسمح للحبوب المحمّصة بالتساقط في يدها. ثم تبدأ بفركها لإزالة القشور. من هنا جاء إسم الفريكةة، مشتقًّا من الفعل “فَرَكَ”.
في السنوات الأخيرة، اكتسب الفريكة شعبية خارج منطقة الشرق الأوسط. وقد أُطلق عليه إسم الغذاء الخارق بسبب قيمته الغذائية الكبيرة، فهو غنيّ بالبروبايوتكس ومضادّات الأكسدة، وكذلك بالكالسيوم والزنك والحديد. وقد بات يُعرف بإسم “الكينوا الجديدة”، فقط بعد أن ذكرته أوبرا في برنامجها – أو كما ورد في مقالة في صحيفة الإندبندنت “الفريكة، أنيق”.


عندما يتمّ تحضير القمح وربطه في حزمات، يحين الوقت لتحميص الحبّات على الموقدة. هكذا تحصل الفريكة على قوامها ونكهتها المميّزة.

لدى علياء ووالدتها ما يكفي من الفريكة لاستهلاكهما الخاصّ، وما يكفي للتبرّع به لأفراد الأسرة أيضًا.
تقول حسنا: “هيدا الشي بيعطيه قيمة تانيه”.
“القصّة إلها علاقة بالكرَم، وقتا بتعطي الناس من أرضك بيزيد الخير”.
تقول وهي تضع بضع حبّات في فمها: “هيك كانوا الناس بالقديم ياكلوا الحبوب بلا تحضير. ما كان عندن مطحنة بهاك الوقت”.
واليوم، يقوم الناس بطهي الفريكة قبل تناوله. ولكن أولاً، وكمرحلة أخيرة بعد التحميص، تُترك الحبوب لتجفّ لمدّة شهر ونصف تقريبًا.